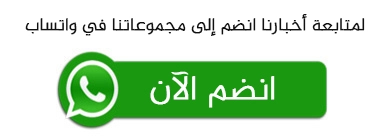د.عبد الله علي إبراهيم
مرت منذ الـ19 من يونيو (حزيران) الجاري الذكرى المئوية لثورة 1924 ضد الاستعمار الإنجليزي في السودان.
وصارت فيناً أيقونة وطنية ساهرة. ولكن تمر مئويتها تحت نار حرب يحاكم فيها طرف “قوات الدعم السريع” دولة 1956 التي غرست بذرتها هذه الثورة كباكورة نضال الحركة الوطنية الحديثة لأجل الاستقلال. وسبق لصفوة الحركة الشعبية لتحرير السودان أن رأت منذ التسعينيات عواراً في ثورة 1924 أخرجت به أثقالاً عرقية بها حيال أفارقة السودان.
التعبير عن إرادة الأمة
كانت الثورة ثمرة صراع حول من له التعبير عن إرادة الأمة السودانية وقيادتها ضد الاستعمار الإنجليزي والمصري الثنائي على البلاد. فتنازع فريقان تلك المنزلة وهما قوى الأعيان من زعماء الطوائف الصوفية والقبائل وبيوت المراتب التقليدية عامة، وقوى “الأفندية” التي خرجت من معطف الاستعمار الذي غلب فيه الإنجليز، فحصلت على الوظائف الدنيا في جهاز الدولة من كتبة ومحاسبين ومترجمين ومساحين ومعلمين من خريجي كلية غردون (1902).
وكان ميل الأعيان لإنجلترا، أرادوها وصياً يأخذ بالبلد حتى تبلغ الحكم الذاتي مستقبلاً، في حين مال الأفندية إلى مصر. وقوى عزائم الأفندية السياسية نجاحهم في تكوين تنظيم سياسي علني هو “اللواء الأبيض” في 1924 ليحمل رأيهم في مالآت بلادهم.
عقيدة الأفندية
وكانت عقيدة الأفندية هؤلاء ليس أن الأعيان طبقة متخلفة عن الحداثة التي شوقتهم لها المعارف الجديدة في المدارس، التي زودتهم باللغة الإنجليزية للاطلاع على مجريات العالم فحسب، بل إنهم أيضاً استذلوا للإنجليز بخلاف عنهم “وفي صحائفنا ما في صحائف من باعوا ضمائرهم للغاصب النهم”. أما الأعيان فاستنكروا من الأفندية طلب قيادة الأمة وهم على ما فيهم من ضعة في الأصل والفصل، فما عرف عنهم الصدارة في القوم دينياً ولا قبلياً.
مرت منذ الـ19 من يونيو الجاري الذكرى المئوية لثورة 1924 ضد الاستعمار الإنجليزي في السودان. وصارت فيناً أيقونة وطنية ساهرة. ولكن تمر مئويتها تحت نار حرب يحاكم فيها طرف “قوات الدعم السريع” دولة 1956 التي غرست بذرتها هذه الثورة كباكورة نضال الحركة الوطنية الحديثة لأجل الاستقلال. وسبق لصفوة الحركة الشعبية لتحرير السودان أن رأت منذ التسعينيات عواراً في ثورة 1924 أخرجت به أثقالاً عرقية بها حيال أفارقة السودان.
التعبير عن إرادة الأمة
كانت الثورة ثمرة صراع حول من له التعبير عن إرادة الأمة السودانية وقيادتها ضد الاستعمار الإنجليزي والمصري الثنائي على البلاد. فتنازع فريقان تلك المنزلة وهما قوى الأعيان من زعماء الطوائف الصوفية والقبائل وبيوت المراتب التقليدية عامة، وقوى “الأفندية” التي خرجت من معطف الاستعمار الذي غلب فيه الإنجليز.
فحصلت على الوظائف الدنيا في جهاز الدولة من كتبة ومحاسبين ومترجمين ومساحين ومعلمين من خريجي كلية غردون (1902). وكان ميل الأعيان لإنجلترا أرادوها وصياً يأخذ بالبلد حتى تبلغ الحكم الذاتي مستقبلاً، في حين مال الأفندية إلى مصر. وقوى عزائم الأفندية السياسية نجاحهم في تكوين تنظيم سياسي علني هو “اللواء الأبيض” في 1924 ليحمل رأيهم في مالآت بلادهم.
عقيدة الأفندية
وكانت عقيدة الأفندية هؤلاء ليس أن الأعيان طبقة متخلفة عن الحداثة التي شوقتهم لها المعارف الجديدة في المدارس، التي زودتهم باللغة الإنجليزية للاطلاع على مجريات العالم فحسب، بل إنهم أيضاً استذلوا للإنجليز بخلاف عنهم “وفي صحائفنا ما في صحائف من باعوا ضمائرهم للغاصب النهم”.
أما الأعيان فاستنكروا من الأفندية طلب قيادة الأمة وهم على ما فيهم من ضعة في الأصل والفصل. فما عرف عنهم الصدارة في القوم دينياً ولا قبلياً.
وخرجت أول تظاهرة للثورة في الـ17 من يونيو 1924 إثر قرار القوتين المستعمرتين المتشاكستين التفاوض في ما بينهما حول وضع السودان. فهرع كل من الأعيان والأفندية لجمع التوقيعات من السودانيين لتعزيز وضع المفاوض الذي يحظى بتأييده.
وحدث أن ألقت الإدارة الاستعمارية القبض على مندوب “اللواء الأبيض” الذي حمل توقيعات تعزيز الجانب المصري في المفاوضات قبل بلوغه مصر. وأعادوه للسودان ليعد “اللواء الأبيض” تظاهرة محدودة لاستقباله في محطة السكة الحديد بالخرطوم. وقامت التظاهرة على رغم غياب المندوب لأن الإنجليز أنزلوه في محطة الخرطوم بحري. ثم أعقبتها تظاهرة أخرى أكبر في الـ19 من يونيو في تشييع مأمور مدينة أم درمان المصري عبدالخالق حسن دعا فيها الخطيب الحاج الشيخ عمر الطالب بمعهد أم درمان العلمي إلى إطاحة الإنجليز والوحدة بين مصر والسودان.
تعلق الثورة بمصر
كان تعلق الثورة بمصر بالغاً. فحمل أنصارها في تظاهراتهم علم “اللواء الأبيض” وعليه رسم نهر النيل من منبعه إلى مصبه والعلم المصري على جانب منه. بل حمل ثوارها العلم المصري نفسه في تظاهرات تلت التظاهرة الأولى حين اشتد نكير الإنجليز عليهم. وكانوا يهتفون باسم الخديوي فؤاد ملكاً على مصر والسودان وبحياة سعد زغلول.
ولم تقتصر التظاهرات على الخرطوم. فعمت البلاد حتى اضطر الإنجليز لاستدعاء فرق إضافية من خارج السودان للمعاونة في حفظ الأمن الذي فلت. وما عمم التظاهرات في أنحاء القطر شمالاً وجنوباً أمران، هما خلايا “اللواء الأبيض في نواحيه وفرق الجيش المصري المبثوثة فيها. فخرجت التظاهرات في بحر أغسطس وشملت بلدات من الصعب القول إنها شاركت حتى في ثورات السودان المتأخرة.
فتظاهرت بورتسودان، وشندي والأبيض وحلفا وأم روابة ودنقلا وأبودليق وأبو حمد وأرقو وكبوشية ودلقو والدامر والفاشر وبارا والدلنج وتلودي وأم روابة وشركيلا وسنجة والكاملين والحصاحيصا والدويم والقطينة وكوستي وواو والرنك وشامبي وكدوك وملكال. وغالباً ما كانت هذه التظاهرات لغرض استقبال معتقل من قادة الحركة مر بواحدة من هذه المدن.
واتخذت التظاهرات صورة عسكرية مرتين. فتظاهر طلاب الكلية الحربية بالزي التشريفي للجيش، ولكنهم مسلحون إذا طرأ ظرف. وحملوا صورة الملك فؤاد والعلم المصري. وساروا حتى دار علي عبد اللطيف الضابط السابق وزعيم الحركة المعتقل ليحيوا العازة، زوجته. وانتهوا معتقلين في باخرة على النيل.
أما الصورة العسكرية الأكثر عنفاً وتضريجاً فكانت بعد اغتيال السير لي استاك الحاكم العام الإنجليزي للسودان في القاهرة في عام 1924. فقررت الحكومة الإنجليزية تفكيك الوجود العسكري لمصر في السودان.
ولم تقبل الفرق السودانية في الجيش المصري ذلك القرار. ففي الـ27 من نوفمبر تمردت الفرقة 11 بقيادة ستة ضباط و120 جندياً وطلبت أن تغادر مع فرق الجيش المصري يداً بيد. وبالفعل تحركت تلك الفرقة إلى الخرطوم بحري لتنضم إلى الجيش المصري هناك لترحل معه.
وخاطبهم هيوبرت هدلستون الحاكم بالإنابة فرفضوا السماع له وطلبوا أن يخاطبهم ضابط مصري. ونشبت معركة بينهم وبين الجيش الإنجليزي خلدتها الوطنية والشعر السودانيين لضروب البطولة التي أظهروها في الدفاع عن أنفسهم.
تأسيس هوية السودان
وجاء العيب لثورة 1924 أخيراً من باب أنها حجر الزاوية الـتأسيسي لحصر هوية السودان على العروبة والإسلام لتنطبع بهما دولته المستقلة في عام 1956 مستبعدة هويات أقوامها الآخرين. فكانت مهمة التحرير الوطني وقعت على جيل الثورة والجيل الذي تلاه من صفوة الشمال النيلي والأوسط العربي المسلم في حين تغيبت عنها صفوات الأقوام الأخرى لأسباب مختلفة. وأعظم تلك الأسباب هو الإدارة الإنجليزية التي اقتطعت جنوب السودان وجبال النوبة ومنطقة النيل الأزرق وجزء من دارفور عن شمال السودان، في ما عرف بـ”المناطق المقفولة” (1922) و”السياسة الجنوبية” (1930). ورتب الإنجليز لتلك المناطق خطة للحكم مستمدة من تقاليدها وعقائدها في سلسلة وحدات عرقية قبلية وإن لم يمنع ذلك من إيكال التعليم فيها للتبشير المسيحي. ولم يرجع الإنجليز عن هذه السياسات إلا في عام 1946 أي قبل عقد من استقلال السودان.
وحاربت الحركة الوطنية في المركز تلك السياسات لأنها قطّعت أواصر الوطن لحجب التأثيرات الإسلامية والعربية التي تقع بالخلطة بين الناس في الوطن.
وكانت حصيلة تلك الجغرافيا السياسية الاستعمارية أن استقلت صفوة المتعلمين الشماليين بـ”تخيل الأمة”، في مفهوم الأكاديمي بنيدكت أندرسون في غياب كامل تقريباً لممثلين من الجماعات السودانية الأخرى. فخلا لهم الجو ليتخيلوا الأمة من “قماش هويتهم الإسلامية العربية”، في قول لإحدى المؤرخات، ولتصادر هويات مختلفة لآخرين شركاء في الوطن.
فحتى غير العربي المسلم في تلك الصفوة مثل النوبي خليل فرح، حادي ثورة 1924، لم يجد كدراً من النسبة للعرب:
أبناء يعرب حيث مجد ربيعة وبنو الجزيرة حيث بيت إياد
متشابهون لدى العراك كأنما نبتت رماحهم مع الأجساد
ووجدت تلك الصفوة في مجد إسلامهم التليد العزاء لهوانهم تحت الاستعمار:
فيا نعم عيش بالشآم وأمرة ببغداد حيتها السعود البواسم
وقد نبغت يوماً بأندلس لنا شؤون أبانت للفرنجة ما همو
وبدت هذه الهوية العربية الإسلامية لمن جاؤوا لحقل العمل العام من قوميات المناطق المقفولة بآخرة وكأنها مؤامرة حبكت من وراء ظهورهم. ولكن الخطأ بالحق ليس في منشأ الهوية العربية الإسلامية أول مرة في مثل ثورة 1924 إذ لم يكن منه مفر في شرط الزمن. فالخطأ الحق هو في لؤم التمسك بها بعد من جاء يعرض هويته المختلفة ويطلب أن تزين قوس قزح الوطن مثل غيرها.
أما باب عيب ثورة 1924 الثاني فجاء من العناصر الشمالية في الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة العقيد جون قرنق. فدخلوا عليها مدخلاً عرقياً أخذها من حقيقتها كحركة وطنية ضد الاستعمار إلى كونها معرضاً آخر لعرقية الشماليين العربية وحزازتهم على أفارقة السودان. فانتخبوا من كل الحركة رمزها القائد علي عبد اللطيف وعمدوه ممثلاً للجنوب، الذي لم يره إلا بوصفه ضابطاً في الجيش المصري، لأنه منه أصلاً غير أن الرق نزع أهله للشمال. وركزت هذه الصفوة الشمالية في الحركة الشعبية على المتاعب التي لقيها في قيادته للحركة الوطنية للأفندية. ووجدوا نصاً في صحيفة “حضارة السودان”، التي كانت لسان حال الأعيان، هاجم حركة 1924 وجاء فيه:
“البلاد أهينت لما تظاهر أصغر وأوضع رجالها دون أن يكون لهم “مركز” في المجتمع، وأن الزوبعة التي أثارها الدهماء قد أزعجت طبقة التجار ورجال المال، وأنها لأمة وضيعة تلك التي يقودها أمثال علي عبد اللطيف، وذلك أن الشعب ينقسم إلى قبائل وبطون وعشائر ولكل منها رئيس أو زعيم أو شيخ وهؤلاء هم أصحاب الحق في الحديث عن البلاد، فمن هو علي عبد اللطيف الذي أصبح مشهوراً حديثاً وإلى أي قبيلة ينتسب؟”.
وضيقت هذه الصفوة واسع النص حين لم توطنه في صراع الأعيان والأفندية حول القيادة ولمن هي في الأمة. فصبت الهجاء الذي جاء فيه في كلياته على عبد اللطيف بقرينة السؤال عمن هو وإلى “أي قبيلة ينتسب؟” وقالوا إن ذلك، وهو بيت القصيد، ما عاناه العقيد جون قرنق الجنوبي حين سأل بعض الناس لماذا نتبعه في دعواه لقيام “السودان الجديد”. وحملت ذلك محمل العرقية مثل التي عاناها علي عبد اللطيف.
ومهما كان من أمر قرنق فنص صحيفة الحضارة أكثر خطراً من مطاعنة علي عبد اللطيف عرقياً. فكان في جوهره رأياً ثقيلاً في ثورة 1924 جمعاء. فبدأ بالتعريض بـ”الدهماء” الوضيعة التي تظاهرت بما أزعج طبقة التجار ورجال المال تريد مركزاً في البلاد ليست أهلاً له. وهم، في نظر الأعيان، الأفندية الذين خرجوا ينازعونهم القيادة الوطنية التي ورثوها كابراً عن كابر. ثم طعن النص في عرق علي عبداللطيف واستحقاقه القيادة حتى على تلك الدهماء كما لا مهرب لمن يريد أن يزري بالثورة جملة واحدة ومن نقطة ضعف أخذوها على قائدها من جهة وضعه الاجتماعي.
ويسأل المرء لماذا قصرت صفوة “الحركة الشعبية” مشاركة الجنوب على رمزها علي عبد اللطيف الذي زعمت أن له منزلة في الجنوب لم تطرأ له. بينما مساهمة الجنوب في الثورة متاحة لو لا بد لمن أراد تحريها. فخرجت في الثورة مدن جنوبية كما تقدم، بمبادرة ضباط سودانيين في الجيش المصري. فسعت خلية للواء الأبيض بقيادة الضابط فرج الله إبراهيم في مدينة واو ببحر الغزال لجمع توقيعات سلاطين في الإقليم لتسند مصر في التفاوض مع الإنجليز.
وصح السؤال أيضاً عن لماذا قصرت صفوة الحركة الشعبية مساهمة الجنوب في الحركة الوطنية على دور علي عبد اللطيف في ثورة 1924. فكانت للجنوبيين بحق مساهمة فيها خرج المؤرخ لجنوب السودان لازاروس ماووت (1950-2009) لبيانها في كتابه “مقاومة الدينكا للحكم الثنائي” (1983). وماووت واع بأنه قادم إلى كتابة تاريخ للحركة الوطنية السودانية في إقليم قل من أخذ دوره فيها مأخذاً جدياً. فحتى أكثر الجنوبيين الذين عانوا من حكومة المركز في الخرطوم تواضعوا على أن سياسة المناطق المقفولة الإنجليزية كانت رحمة بهم لأنها حمتهم من “استعمار” الشمال. وخلافاً لهؤلاء يعتقد لازاروس أن الاستعمار كان واقعة صادمت الوطنية الجنوبية فاستنهضت هممها للمقاومة. وعرض لضروب المقاومة التي شنها شعب الدينكا ضد الاستعمار الإنجليزي في الأعوام ما بين 1902 و1934.
وخلافاً لمن طابقوا بين علي عبد اللطيف وقرنق للتعريض بالعرقية في ثورة 1924 سأل الصحافي ضياء الدين البلال صفوة الشمال في الحركة إن كانت رمزية علي عبد اللطيف في الثورة خيار الجنوبيين أم خيارهم هم. فإن كانت خيارهم هم لا الجنوبيين فلربما لأنهم استصعبوا هم أنفسهم قبول قيادة جنوبية مثل قرنق عليهم بغير مسوغ من التاريخ.
يقال إن العقل أولى ضحايا الحرب. وصح القول أيضاً إن ضحيتها الأبرز هو التاريخ. بل هو الضحية الأولى التي تسبق الحرب نفسها. فرأينا كيف جرجرنا واقعة بنت زمانها ومكانها في الماضي إلى صراعات عاقبة لها أفرغتها من دلالتها في زمانها. ولا يعرف المرء إن كانت هذه الجرجرة، على عواهنها، أعانت من قاموا بها على فهم حاضرهم.
IbrahimA@missouri.edu