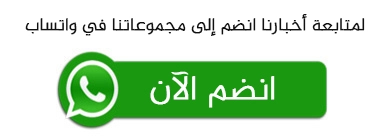في خضم العاصفة السودانية، تبدو الولايات المتحدة كما لو أنها تمارس لعبة “شطرنج” على رقعة من الرماد. لتثبيت توازن هش.
غير أن هذا التوازن بدأ يهتز مع تصاعد التحولات الإقليمية، وعلى رأسها التقارب السوداني–التركي، الذي تجاوز الإطار الرمزي الدبلوماسي إلى التعاون العسكري المباشر، بما في ذلك صفقات السلاح والدعم اللوجستي.
تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ضد “مليشيا الدعم السريع” بدت للبعض تحولاً في الموقف الأمريكي، لكنها في الحقيقة طعماً دبلوماسياً يهدف إلى إعادة توجيه الحكومة السودانية بعيداً عن محور “أنقرة”، وإلى تحييد نزعتها السيادية المتصاعدة، التي عبرت عنها بإصرارها على شروط لقبول مقترح “الهدنة”، وعلى وجود “تركيا” ضمن اللجنة الرباعية الدولية.
فالولايات المتحدة تنظر إلى “الرباعية” من زاوية إدارة النفوذ داخل الإقليم. إن وجود السودان داخل هذه المنظومة يعني بقاءه في الفلك الغربي، حيث تظل القرارات المصيرية تمر عبر قنوات تضمن حماية المصالح الأمريكية في البحر الأحمر.
لكن التناقض سرعان ما انكشف، حين جاءت تصريحات المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي، مسعد بوليس، لتناقض خطاب وزير الخارجية، وتعيد الأمور إلى نقطة الصفر. ذلك التناقض ليس مجرد اختلاف في التقدير، بل تكتيك مؤسساتي مقصود يعكس ازدواجية الخطاب الأمريكي: خطاب مبدئي موجه للرأي العام، وآخر واقعي موجه لصناع القرار وحلفائهم في الخليج.
إن واشنطن لا يمكنها أن تُغضب الإمارات، أحد أهم ركائزها المالية والسياسية في الشرق الأوسط، ولا أن تمس بمصالح الرئيس “دونالد ترامب”، الذي ما يزال يمثل بشكل أو بآخر رأسمالاً سياسياً واقتصادياً نافذاً في الخليج. ولذلك، فإن أي تهديد مباشر للمليشيا المدعومة من “أبوظبي” سيعني المساس بالبنية العميقة للنفوذ الأمريكي غير الرسمي في المنطقة.
في تقديري، الحكومة السودانية تهدر الوقت في انتظار إنصاف أمريكي لن يأتي، فيما المدن تتساقط تباعاً، والمليشيا تتمدد في الجغرافيا والسياسة معاً.
واشنطن لا ترى في السودان دولة يجب إنقاذها، بل مسرحاً لإعادة هندسة النفوذ في إفريقيا والبحر الأحمر.
وستمر الأيام لتثبت التجارب أن المصالح الأمريكية في السودان أهم من أمنه واستقراره، وأن الولايات المتحدة، كما في تجاربها التاريخية الأخرى، تتغذى على الفوضى التي تصنعها، حتى تضعف الدولة السودانية وتتحول إلى كيان قابل للتطويع.