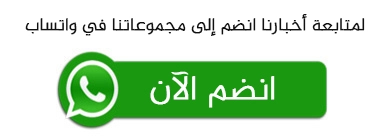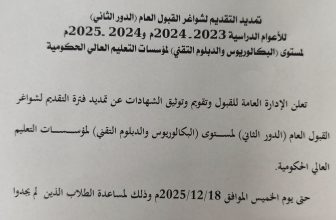تعرضت مدينة الفاشر في إقليم شمال دارفور غربي السودان لنكبة لا مثيل لها في تاريخها الحديث، فبعد أشهر من الحصار وإطلاق القذائف، التي لم تفرق كثيرا بين ما هو مدني وعسكري، تهاوت أخيرا بين يدي جنود الجنرال المتمرد محمد حمدان دقلو «حميدتي». تعاطف العالم مع هذه الأحداث، خاصة بعد أن قام أفراد ميليشيا «الجنجويد» بنشر صور لانتهاكات شاركوا فيها. هذه الصور والفيديوهات المرعبة جعلت اسم الفاشر معروفا على صعيد العالم، الذي لم يملك فاعلوه إلا أن يتعاطفوا مع الضحايا.
في داخل السودان أيضا أخذ موضوع انتهاكات الفاشر اهتماما كبيرا، فعلى الرغم من أن أغلب الأهالي في وسط وشمال السودان قد ذاقوا جحيما مماثلا، حينما مرّ هؤلاء المجرمون بديارهم، وعلى الرغم من أن الجرائم السابقة كانت أيضا موثقة من قبل مرتكبيها، إلا أن الكثيرين أرادوا أن يتعاملوا مع حدث الفاشر كأمر فريد من نوعه.
ربما نعود في مقال لاحق لمحاولة تحليل أسباب ذلك التركيز الخارجي المكثف على موضوع انتهاكات الفاشر، خاصة من قبل أطراف كانت تلتزم الصمت طوال أشهر على انتهاكات مماثلة.
سنسهب هناك في التعليق والتعليل، لأن الأمر لا يتعلق بالخارج فقط، بل بالداخل أيضا، فلا نوع الانتهاكات ولا أهمية المدينة يبرّران ما يقال عنها حاليا من عبارات وأوصاف، من قبيل أنها نقطة تحول في مسار الحرب، أو أنها علامة فارقة لا تشابه غيرها، أو غيرها من العبارات، التي بدأ كثيرون ترديدها دون وعي، لدرجة أنه، وحتى حينما تمدد الجنجويد أكثر ليسقطوا مدينة بابنوسة المهمة في إقليم غرب كردفان، فإن الناس كانوا ما يزالون مشغولين بالفاشر، ما كان يوحي بأن تمدد الجنجويد عبر المدن الأخرى غير مهم، أو أنه كان يتم بلا خسائر ولا انتهاكات.
الذي حدث إثر هذا هو، أن الناس سمعوا عن ولادة معسكر في محلية الدبة في شمال السودان، وأن آلاف النازحين والهاربين بحياتهم قد وصلوا إليه. لأنه كان هناك تركيز إعلامي، فقد تفاعل أبناء المنطقة وغيرهم من أبناء السودان بشكل كبير مع الأمر، وتدافعوا لتقديم المال والعون والإسناد للواصلين الجدد، في مشاهد عفوية كانت تعبر عن الكرم وعن الأصل الطيب.
هذه اللحظة العاطفية لم تلبث أن خفتت، ومع تواصل توافد أعداد جديدة من النازحين تولدت عشرات الأسئلة عند الأهالي والمتابعين. أهم هذه الأسئلة كان عن طريقة وصول هذه الأعداد، التي تقدر بعشرات الآلاف، من قلب إقليم دارفور، الذي يسيطر الجنجويد عليه بشكل شبه تام، إلى الدبة. تولد عن هذا السؤال سؤال آخر، فهؤلاء الواصلون يبدو كثير منهم بصحة جيدة وفي عمر الشباب، فهل هؤلاء هم أنفسهم، الذين كانوا محاصرين منذ عامين، والذين كنا نسمع أنهم كانوا يعيشون على غذاء الحيوانات وعلى جلودها؟ التفكير لا يقف هنا، حيث يقفز سؤال آخر إلى الذهن وهو: هل هؤلاء قادمون من الفاشر حقا، أم أن المعسكر وما توفر فيه من مسكن وغذاء كان جاذبا للكثيرين ممكن كانوا بلا سكن من نواحي السودان المختلفة؟ هذا السؤال بالذات كان صعبا، فأنت تتحدث عن مجموعة توصف بأنها «فرت بحياتها». هذا التوصيف يجعلها غير مطالبة بأوراق تثبت انتماءها للسودان، ناهيك من إثبات انتمائها للمدينة المنكوبة. معسكر النازحين كان مكلفا بلا شك، ووفق ما أشيع فقد كان برعاية أحد الرجال، الذين يجمعون بين المال والأعمال والإحسان. بالنسبة للأهالي فإن هذا الأمر نفسه كان محل تساؤل، فمن أين ظهر هذا الرجل الكريم، الذي لم يتردد في دفع الملايين من أجل إعانة النازحين؟ هل هو من أهل المنطقة؟ إذا لم يكن من أهل المنطقة، فلماذا فكر بتجميع هذا العدد من القادمين في هذه البقعة الواقعة شرق النهر بالتحديد، ولماذا لم يختر مدينة أقرب لديارهم؟ أما إذا كان من أهل المنطقة فإنه يظل أمرا غريبا أن يكون مختفيا منذ اندلاع الحرب، حينما كانت هذه المناطق تتعرض، إلى جانب تهديدات حميدتي، إلى كوارث طبيعية وإلى وفود نازحين آخرين من الخرطوم وود مدني وغيرها من البقاع، التي بدأ بها الجنجويد انتهاكاتهم. هذه الأسئلة كانت متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، لكنها كانت تقابل بالكثير من التقليل والتهميش والسخرية، مع اتهام أصحابها بأنهم رافضون لمساعدة المحتاجين، أو يأنهم عنصريون، يرفضون الوافدين لمجرد أنهم قادمون من دارفور.
للقفز على هذه الأسئلة كان كثير ممن يتبرعون بالرد، ويكتفون بالقول إن أولئك النازحين، هم في خاتمة المطاف سودانيون، وبذلك فإن من حقهم الوجود في أي بقعة من البلاد بأي طريقة، ومن دون أخذ إذن. هذه العبارة تبدو منطقية في ظاهرها، وربما لو كان الوضع طبيعيا لكانت مقنعة، لكن الذين يردون بهذا التبسيط على هواجس الناس وأسئلتهم، يتناسون الهزة الاجتماعية، التي أحدثتها الحرب. صحيح أن خطاب حميدتي الإعلامي كان يركز على الهجوم على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وعلى رموز النظام السابق، الذين زعم أنه يحاربهم، إلا أن الواقع يخبر أن هذه الرسائل كانت للاستهلاك الخارجي فقط، أما الخطاب الحقيقي والواقعي، الذي كانت تستخدمه الميليشيا، من أجل التحشيد الجماهيري ومن أجل استنفار المتحمسين، فقد كان خطاب القبيلة العنصري، الذي يصور هذه الحرب على كونها، كما وصفها أحدهم، «حرب الغرابة على الجلابة»، أي حرب أبناء الغرب على أبناء الوسط والشمال. المتخوفون والمتوجسون لا يتوجسون بلا سبب، بل هم ببساطة قلقون على مستقبلهم، وعلى مستقبل أحبائهم، ولا يريدون أن يشهدوا تكرار المأساة. لا يريد أولئك أن يستيقظوا ليجدوا أن مدنهم الصغيرة وقراهم، التي لا يتعدى سكانها في الغالب بضعة آلاف صارت محاصرة بأعداد تفوق أعداد السكان المحليين، بالكثير من الذين، مهما قيل عنهم، يظلون من الغرباء، الذين لا يعرف أحد خلفياتهم ولا سجلاتهم المدنية والجنائية، ولا تاريخهم الطبي، ولا حتى مدى ارتباطهم بالجماعات المقاتلة. نحن لا نتحدث عن مجرمين، بل عن ضحايا هم أبعد ما يكونون عن الجنجويد، هكذا يقول المتحمسون للمعسكر الناشئ والقائمون عليه. تلك العبارة أيضا، على ما فيها من صحة ظاهرية، تتجاهل الحاجز النفسي، الذي تولد منذ اندلاع الحرب، والذي غذته الانتهاكات العنصرية وأعمال التطهير العرقي والتهجير الممنهج، الذي كان السمة الأبرز للحرب. إذا قلت لأولئك المتحفظين إن هؤلاء النازحين هم من قبائل منافسة لقبائل الجنجويد، وإنهم لا يمكن أن يعودوا للتحالف معهم، بل إنهم قد يكونون أقرب لمجموعة «الزغاوة»، التي تقاتل حركاتها المسلحة مع الجيش، فسوف يقولون لك بدورهم: وهل تضمن أن هذه الحركات، التي تقاتل مع الجيش حاليا، والتي كانت متمردة لقرابة العقدين من الزمان على الدولة، لن تعود للتمرد مجددا، وماذا سيكون مصير أهلنا ومناطقنا إذا حدث ذلك ونحن محاطون بكل أولئك المقربين للمتمردين المحتملين؟
ما يجعل كل هذه الأسئلة والمخاوف مشروعة هو أنه لا يوجد من أو ما يضمن ألا يتكرر السيناريو السيئ مجددا بأطراف وفاعلين آخرين، فتاريخ السودان الحديث حافل بتغير الأدوار وتبدل السيناريوهات.