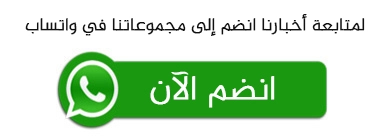في بداية تسعينات القرن الماضي، والزمان كآبة، قادتني خطايا إلى منزلٍ يقع على ناصية من نواصي حي بانت شرق العريق فى مدينة ام أدرمان، طرقتُ الباب بكل ثقة، لا أدري من أين أتيت بها، وبعد برهةٍ قصيرة خرج رجلُ طويل القامة، أو هكذا خيُّل لي لحظتها ، قابلني مبتسماً، طلب مني الدخول دون أن يعرف هوية الشاب المُعفّر بالتراب، منكوش الشعر، نحيل الجسد، وذى العدسات الطبية السميكة على عينيه التى تخفى ورائها قلق تلك الأيام وكذلك هالة الاعجاب بشاعر الشعب الذى يشمخ بتواضع جم .
قدمتُ نفسي له كصحافي مبتدئ، متعاون مع صحيفة ” عكاظ السعودية” في قسمها الثقافي، أخبرته برغبتي إجراء حوارٍ صحفي معه، رحب بكل سرور، ثم نهض وأحضر العصير والشاي ، لا أدري كيف واتتنى الجرأة حينها لاقتحام عالم ذلك المبدع المهيب، الذي كان يعيش أول سنوات حصاره باشواك المشروع الحضاري الكذوب.
بدأنا نتجاذب أطراف الحديث كصديقين قديمين، تدفق في الحكي بعذوبة، وبعد فترةٍ قاطعته قائلاً ” أنا أعرف أنك شاعر الملحمة، وكاتب مسرحية نبتة حبيبتي وديوان جواب مسجل للبلد، لكني لم أتوقع أن تكون أنت شاعر أغنية النهاية لسيد خليفة.
ضحك وقال لي ، نعم كثيرون يستغربون ذلك لدرجة أن أحدهم حكى لي عن شاعر النهاية الذي أصابه الجنون، ضحك وقال ” قال لي إن الشاعر جاء يوم زواج حبيبته وتفاجأ بوجودها في كوشة العرس، خرج باكيا, وكتب قصيدته تلك، ثم ذهب الى نهر النيل وغرقّ! وهو لا يعرف ان كاتب القصيدة هو الذي يحكي له عن انتحار العاشق الولهان.
ضحكتُ وأعرف أننا؛ هكذا نحن نضع لكل قصيدة قصة، ولكل قصة حكاية أسطورية، تنتهي بجنون الشاعر أو موته :
حسيت شعور الراهب السار السنين
مشتاق يفتش ليهو دير
لمن تعب سارت خطاهو علي الدرب
خاف الأمل كره المسير
يا حبي عيش كلمات خطاب
من الحبيب كان النهاية..
ويوم في يوم غريب فيهو الشمس لمت غروبها وسافرت.
ليس من السهل الربط ما بين شاعر الملحمة، وبين تلك الكلمات الرومانسية الموشَّحة بهمس الشوق، المطرزة بشتول المحنة، المحتشدة باللَّوعة على فراق الحبيب، صفات رقة لا تتوفر حسب الصور النمطية في شاعرٍ ثوريً فخيم، ردد معه كل السودانيين، وعلى اختلاف الأجيال، وبذات المهابة والاجلال والحس الثوري الرهيب :
وفي ليلة و كنا حشود بتصارع
عهد الظلم الشبَّ حواجز، شبَّ موانع.
جانا هتاف من عند الشارع..
قسماً قسماً لن ننهار.
طريق الثورة هدى الأحرار..
والشارع ثار.
والكل يا وطني حشود ثوار..
عندما كتب هاشم صديق، قصيدة الملحمة، أو ” قصة ثورة” كان في مهد الشعر صبياً، في الثامنة عشر من عمره، شاباً يافعاً، مملوءً بالحماس الوطني، وبزهو الشباب الغر الميامين،، كان فرحاً بتفجير أول فعلٍ ثوري في المنطقة أطاح بنظامٍ عسكري ديكتاتوري، في أكتوبر ١٩٦٤، لذا ارتبط هاشم بالأكتوبريات والثورات والملاحم العظيمة.
وعلاقة هاشم بالوطن لا ببتبدي، لا بتنته، حاجة زي وتر الموانئ لما يصدح لسفينة، فالوطن عنده انتماء له جذور عميقة، مغروسة في جرف الأرض، ” معطّونة” من عطر الطلح، معجونة من بيوت الطين والرواكيب
الليلة زارتنا الرؤى المنسوجـة من عمق الجذور
رسمت صور ضوت جمــال
وجوة الخيال عاشت دهور أفراح فريق يوم الحصــاد وجريف يضم طينو البذور
فهو ملح الأرض، وصوت الشعب، ونبض الشارع في ليالي الظلم المدلهمات،وفي صباحات الحب البهيات، يحمل جينات الناس الطيبين.
اسمى هاشم، وأمي آمنة
ابويا ميِّت وكان خُضرجى
ومرة صاحب قهوه فى ركن الوزارة ..
بيتنا جالوص واقع مشرم ..
ولما حال الطين يحنن نشقى شان يلقى الزبالة
هاشم، شاعر ثوري بسيط، متواضع، مصادم، بل ظلَّ أحد رموز الصمود في وجه أعتى الدكتاتوريات، لم يهادن يوماً، كيف يهادن ؟ وهو العنيد، المتحدي، المطالب دوماً بفتح دفاتر الأحزان :
منو الربحان؟ منو الخاسر؟
منو الكاتل؟ منو المكتول؟
منو العسكر مع الطغيان؟ منو السلم صغارو الغول؟
الشاعر القوي، الزاحف فوق جمر الصراع منذ ميعة الصبا، و حتى رحلته الأخيرة فوق ظهر ” كارو” نعى بها الوطن قبل أن ينعي نفسه، لقد كلفته مواقفه الصدامية الكثير، أفقدته الوظيفة، أوقفت برامجه التلفزيونية، لكنه لم يفقد ألقه، وإن أفتقده الوطن عندما فصلته الانقاذ من وظيفته كأستاذ في المعهد العالي للموسيقى والمسرح، والمعهد عالمٌ آخر من عوالم هاشم الكرنفالية الفريدة، فهو أكاديمي يدرس النقد المسرحي، وكاتب درامي مجيد، فمن من أجيال ما قبل الانقاذ لا يتذكر طائر الشفق الغريب؟، ولم يركب بخياله في عربات قطر الهم؟
قطر ماشى وعم الزين وكيل صنفور.
وزي ما الدنيا سكة طويلة
مرة تعدي ومرة تهدي مرة تدور
عم الزين محكر في قطار الهم يشرق يوم ويغرب يوم شهور ودهور
وحفظنا السكة محطة محطة.
جبل موية، جبل عطشان، جبل رويان ود الحوري وود النيل وود سجمان
وحتى الناظر وجرسو النايم ولون المكتب وعرس الناس الماشي يناهد بالكيمان ..
لقد شكَّلت مسلسلات هاشم علامات فارقة في تاريخ الدراما السودانية، وجعلت الناس يحتشدون حول ” الروادي ” يومياً عند الساعة الرابعة إلا ربعاً عصرا، أو بعد إفطار رمضان، مباشرةً، كان الناس يحتفون بمسلسل ” الحراز والمطر”.
ولكني واقف في المدى..
عايش أنا.. ودايس على الإبر المسممة بالكلام…
كنا نحفظ حوارات المسلسلات، تعرف أبطالها، نعيش تفاصيلهم لدرجة أن نبض القلب الصغير يوشك على التوقف خوفاً من غدرٍ على البطل، أو البطلة، تدغدغنا الموسيقى التصويرية والكلمات والأغاني، وثنائية هاشم وعركي البخيت في تلك الأزمان :
كل البنات أمونة يا خرطوم
معاي ساعة أفتح الدكان..
معاي ساعة الدرس بالليل..
معاي في البص على أم درمان..
وفى الكبرى الكبير بالليل..
أعاين في البحر مهموم ..
ألاقي وجيها شاقي النيل..
هل رحلت أيها الكبير؟؟
لأنَّ الكبرى الكبير في الليل، لا يقودك إلى أم درمان، لكنه يقودك الى الجحيم والتهلكة، هل تظن أنَّ شارع النيل هو الشارع ذاته؟ لن تنظرك أمونة يا هاشم في أم درمان، ولا أدري ان كانت لا تزال تتوشح بثياب الحياء وترفل في نعيم الحب والسلام؟ وهل كبري أم درمان ممراً للحياة، أم ممرٌ للموت؟ ليس هو هذا الذي يحرسه القناصة والقتلة والمقتولون، تبدَّلت المعالم، وتغيرت الصور وصارت المدينة، هي ذات التي أوصفها صديقي الشاعر أبكر آدم إسماعيل بقوله :
إني أرى شجراً يسير”
أراه في سطر المدى
وأرى المدينة في احتراق جحيمها
وفوقها عربٌ تدق خيامها بين المطامير، العمارات، الشوارع..
ليس ثمة من سؤالٍ عن مواقيت الرحيل.
وأرى التفاصيل العويصة في اشتعال السوق.
في كيميا التحلل والذبول.
والنوق ترتع، ثم ترجع، ثم تبعر فوق أسفلت الشوارع،
يا شعراء الشعب ، كيف تنبأتم بهذه الكوارث؟ وكيف عرفت يا أبكر، ان النوق ترتعُ ثم ترجع ثم تبعر فوق أسفلت الشوارع وتردي يا هاشم؟؟ ..
إنَّ كل حياتنا عبارة عن دراما كبيرة، فقصائدك ومسلسلاتك هي تصويرٌ دقيق لهذه المآسي، ونقل بقلب شاعر مرهف، شفاف، يبصر ما لا يبصره من في قلوبهم مرض، وفوق عيونهم غلالات الغل والحقد الدفين على هذا الشعب المنكوب.
وما عادت يا شاعرنا نبتة هي نبتة، بل لا زال الكهنة يذبحون الصبيان فوق أدراج المعابد، ولا يزال السحرة يقذفون بالفتيات مجندلاتٍ إلى أعماق نهر النيل عرائساً تفترسها التماسيح، وما أقسى تماسيحنا!.
وأنت يا هاشم يا ود آمنة، تطهرت من دنس الطغاة، وتقدمت الصفوف فارساً مثل صديقك فارماس بطل مسرحيتك “نبتة حبيبتي”، تقاوم كهنة المعابد، تهتف في الرفاق ” لا تنسوا الغنا شان نثبت ساعة الحرابة”.
وفارسك فارماس، رمز الشرف، وشرف الكلمة، وكلمة حق.
وشان الناس تحس تطرب
وقفت أنادي في الأزمان
طهارة الكلمة في الفنان
وصدق الحرف في صدقو
وّاذا ما عدنا إلى حكاية “النهاية” ورقة الشاعر الثوري، لا بد من الإشارة إلى أن هاشم، كان مرهف الحس، متوهج العواطف، شاعر “حروف اسمك” عقد منضوم بخيط النور، وطلة وردة من السور .. وهل من رقة كلمات مثل “همس الشوق”؟ و”حاجة فيك” زي نقر الأصابع لما تطرب للموسيقى، وما يميز ابداع هاشم، هو قدرته على الإمساك بمفردات يراها البعض عادية، لكنه يلونها، يحشدها بالصور، ينفخ فيها الروح ثم يطلقها في فضاءات الشعر عصفورةً تغني “زي نغمة في مقطع”، وهكذا علاقة هاشم بالشعر، مثل علاقة القصيدة بجرسها الداخلي، وعلاقة السفن بالموانئ والبحر بالسواحل.
رحم الله هاشماً، لقد كان مبدعاً متعدد المواهب، عاشق للوطن، وعاشقاً للناس والنيل؛ يطوٍّع الكلمات وفق ما يهوى، سهلاً ممتنعاً، فهو مدرسة متفردة، أحد رواد الشعر الرمزي، وأحد ملاك ناصية الحرف الأنيق، المفردات الجديدة، الثورة المتدفقة والعواطف العنيفة الدفَّاقة.
ألفين سلام يايمة ياشتل المحنة الشب في وسط الجروف
ألفين سلام يايابا يالدرع المتين الليهو كم سجدت سيوف
ألفين سلام ياجـدة ياأم صوتاً حنين حجواتا بالوادي تطوف